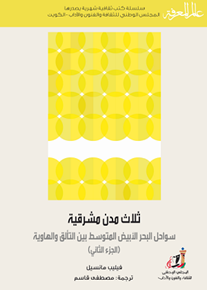عالم المعرفة
عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي، وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير عام 1978 .تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة.
للتواصل: [email protected]
عالم المعرفة تفوز بالمركز الثالث لأفضل سلسلة مترجمة. للمزيد اضغط هنا
إبادة الكتب
العدد: 461
هذا الكتاب:
إن الهجمات التي تستهدف الممتلكات الثقافية أكبر من مجرد تخريب لأعيان مدنية، فهي في جوهرها ترمي إلى محو تاريخ البشر وتراثهم والحط من إنسانيتهم، لذا فإن هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. ويشير مصطلح "إبادة الكتب" تحديدا إلى الحملات المتعمدة لتدمير الكتب والمكتبات على نطاق عريض برعاية أنظمة سياسية في القرن العشرين.
يتناول هذا الكتاب ظاهرة حرق الكتب في القرن العشرين، وردود الأفعال على تدمير الأعيان الثقافية، مع الإشارة إلى ما يربط هذه الظاهرة بجريمتي الإبادة الجماعية والعرقية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ظهور المكتبات ووظيفتها، وروابط المكتبات بالتاريخ والذاكرة الجمعية والهوية والتنمية. ويتمحور الجانب الأكبر من الكتاب حول الإطار النظري لإبادة الكتب، وخمس دراسات حالة: تدمير كل من النازيين والصرب ونظام صدام حسين والماويين والشيوعيين الصينيين للممتلكات الثقافية في أوروبا والبوسنة والكويت والصين والتبت، ويعرض في الختام الصدام بين الأيديولوجيات المتطرفة والنزعة الإنسية، ونظرة كل فريق إلى وظيفة الكتاب والمكتبات، كما يعرض لتطور القانون الدولي وآليات الحيلولة دون تدمير الممتلكات الثقافية أو تخريبها أو نهبها.
ترى الكاتبة، إجمالا، أن حملات إبادة الكتب ليست مجرد جرائم عشوائية يرتكبها برابرة وظلاميون، بل وسيلة من وسائل شن الحرب تتسم بأنها عمدية ومنهجية، توظف العنف لحرمان جماعة ما من حقوقها لخدمة أيديولوجية متطرفة، كما ترى أن محارق الكتب في القرن العشرين مرآة للمعارك بين الأيديولوجيات المتطرفة والنزعة الإنسية الديمقراطية.
$1.00
دولة الإرهاب
العدد: 460
هذا الكتاب:
لماذا طال الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني كل هذه السنين من دون أن يبدو أن ثمة حلا يلوح في الأفق؟ يثبت توماس سواريز في هذا الكتاب، الذي يقوم على بحث بالغ التدقيق في الوثائق والمصادر التاريخية، أن السبب ليس صراعا بين جماعتين عرقيتين مختلفتين هما العرب واليهود، كما يقال في العادة، بل هو اغتصاب فلسطين بالقوة على يد الصهيونية، التي ما هي إلا حركة استيطانية أوروبية تعود أصولها إلى عهد الحركات القومية القائمة على العنصرية.
$1.00
تاريخ المخابرات
العدد: 459
هذا الكتاب:
إن تسليط الضوء على الصراعات بين الدول العظمى يؤكد، بنحو لا يقبل الشك، أن هذه الدول تريد المواجهة، أي تسعى إلى اختبار مدى صمود القوة المناوئة أمام تحديات الخصوم، لكنها لا ترغب في خوض حرب مباشرة مع دولة مناوئة عظمى. وهكذا فإن خيارها العملي يكمن في الدخول في حرب غير مباشرة، حرب تخوضها أطراف أخرى بالنيابة عنها، والاستعانة بترسانة العمليات التجسسية وأبواق الدعاية المختلفة وما سوى ذلك من أساليب أخرى كثيرة.
وانطلاقا من هذه الحقيقة، لا غرو أن تكتسب عمليات التجسس أهمية لم يكن لها نظير في التاريخ السياسي الحديث، فأجهزة المخابرات لم تعد مجرد وسيلة مكملة لما لدى الدول من قوة سياسية، بل أمست بديلا من حرب باتت القوى العظمة لا تريد التورط فيها، أو الانزلاق إليها على خلفية تزايد الترسانة النووية. وكان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان قد أشار إلى هذه الحقيقة بصريح العبارة، حينما قال بعد مرور نحو ثلاثة عقود على الحرب الكورية: "إن الحرب النووية لا منتصر فيها، ومن ثم لا يجوز التورط فيها أبدا". ومعنى هذه التصورات هو أن القوى العظمى لم يعد لديها خيار آخر غير خوض حروب استخباراتية من مختلف الأصناف. تجدر الإشارة إلى أن هذا الخيار تطور بنحو تدريجي وكيف نفسه مع خصائص مسارح العمليات الحربية.
وحينما نمعن النظر في مراحل هذا التطور، فإننا نلاحظ في يسر أنه لا مجال للمقارنة بين دور العيون والجواسيس الذين عاصروا الإسكندر المقدوني وعمليات التجسس المستعينة بالكمبيوتر والأقمار الاصطناعية. وعلى الرغم من هذا البون الشاسع يبقى ثمة تشابه كبير بين المبادئ السياسية الأساسية، والأصول العسكرية التي تميزت بها الدول في عصور التاريخ القديم والعصور الحديثة. فالفزع من خطر داهم مصدره خصوم هم من أبناء الوطن، أو أعداء من رعايا دول أجنبية، يظل يشكل عاملا مستديما في سياسات الدول المختلفة، سواء كان هذا الفزع له ما يبرره، أو كان مصدره يمكن في هلوسة سياسية وجنون الاضطهاد (Paranoia). وتنشأ عن مشاعر الفزع هذه حاجة ماسة إلى التجسس على الخصم المحتمل، بغية التعرف على نياته واستعداداته وقدراته، وأخذا للحيطة واستباقا لنياته العدوانية. إن هذا الأساس السياسي والنفسي كان، على مر عصور التاريخ المختلفة، التربة المناسبة لتنامي الأجهزة الأمنية، عددا وعدة، ولتكاثر العيون والجواسيس.
$1.00
الشبكة الإنسانية
العدد: 458
هذا الكتاب:
استحالت جماعات صغيرة متفرقة، لا يزيد عددها مجتمعة على بضعة ملايين، يعيش بعضها في عزلة وغفلة شبه تامتين عن بعضها الآخر، ولا تستغل من طاقة الأرض ومواردها إلا ما يقيم أودها لعمرها القصير قبل نحو ستة أو سبعة آلاف سنة، إلى "قرية كونية" تجمع اليوم عبر أركان العالم الأربعة ما يزيد على ستة مليارات إنسان في اتصال وثيق وتفاعل مكثف وحركية دؤوبة، يستغلون من طاقة الأرض ومواردها ما يزيد على ثمانين ضعف ما كان أسلافهم الأوائل يستغلونه، ويتمتعون بمتوسط عمري وحالة صحية ونظام غذائي ومستوى رفاه أعلى إلى حد لا يقارن بهؤلاء الأسلاف. فكيف حدث هذا التحول الضخم في حظوظ البشر؟
يقدم كتاب "الشبكة الإنسانية" الذي ينتمي إلى مبحث التاريخ العالمي، رؤية للتاريخ الإنساني تبرز أنماط التعاون والصراع بين جماعات البشر المختلفة عبر شبكات الاتصال والتفاعل التي تشكلت بينهم قديما، وأخذت تزداد كثافة وإحكاما على مر السنين، وبفضلها انتقلت الأفكار والتقنيات والطموحات بين الجماعات البشرية، وأدمجت كل الجماعات في شبكة عالمية موحدة تمثل دوامة من الاتصال والتفاعل المتواصلين. فمن خلال الشبكات تعارف البشر وتعاونوا وتنافسوا وتصارعوا، ما أسهم في تقدم المجموع. وقد انتقل مركز الشبكة -أو الشبكات- الذي نسميه الحضارات من منطقة إلى أخرى، بدءا من ممر "النيل-السند" ومع كل انتقال، كانت الشبكة تزداد إحكاما وكثافة وتزيد المجتمع الإنساني تعقيدا -أي تحضرا- حتى وصلنا إلى الحضارة الإنسانية المعاصرة التي تعد نتاجا لإسهام كل الثقافات والأمم.
$1.00
ألمانيا والشرق الأوسط
العدد: 457
هذا الكتاب:
يضم هذا الكتاب بين دفتيه موسوعة مرجعية، أخذت على عاتقها مهمة تقديم عرض شامل وجامع للعلاقة التي ربطت ألمانيا بالمشرق العربي منذ عهد القيصر فيلهلم الثاني، وإبان الحرب العالمية الأولى، مرورا بمرحلة ما بين الحربين العالميتين، وبالموقف الألماني من تأسيس إسرائيل، وعلاقات التجاذب التي قامت بين ألمانيا والدول العربية، وحربي يونيو وأكتوبر، وانتهاء بالسياسة التي انتهجتها ألمانيا حيال الشرق الأوسط بعد توحيد الألمانيتين وحتى اليوم.
لقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة المراحل المختلفة التي مرت بها السياسة الألمانية في الشرق الأوسط، غير أن الأمر الذي كان يفتقر إليه لإتمام حلقات هذه السلسلة هو تقديم ملخص شامل وجامع لهذه الكتب، وهذا هو بالضبط ما يضطلع به هذا الكتاب، منطلقا من أساس نتائج الأبحاث التي ضمتها دفات الكتب الحديثة التي صدرت أخيرا، ومن تحليل وتقييم الأرشيف الضخم لوزارة الخارجية الألمانية، وتقارير الدبلوماسيين في مختلف المراحل التي يستعرضها.
$1.00
رؤية الأشياء كما هي
العدد: 456
هذا الكتاب:
لم تتخلص الفلسفة مطلقا من تاريخها، فكثير من أخطاء الماضي لا يزال موجودا حتى اليوم، وفي هذا الكتاب يزودنا المؤلف -وهو فيلسوف بارز- بشرح لمضمون تجاربنا الإدراكية وكيفية ارتباطها بالعالم الحقيقي الذي ندركه. وخلال لك، يجادل المؤلف ضد خطأ واحد محدد يرى أنه أرهق تفكيرنا بشأن الإدراك، منذ القرن السابع عشر، ولا يزال شديد التأثير حتى الآن: وهو الفكرة القائلة إننا لا نستطيع أن ندرك مباشرة سوى تجاربنا الشخصانية الخاصة، لكننا لا نستطيع مطلقا أن ندرك الموضوعات وظروف العالم في حد ذاتها، وهي الفكرة التي يشير إليها المؤلف باسم "الحجة السيئة".
يعرف المؤلف هذه المغالطة باعتبارها مصدر الأغلبية العظمى من حالات الالتباس في تاريخ فلسفة الإدراك. ومن هذا المنظور، فالواقع الوحيد الذي يمكننا الوصول إليه هو الواقع الشخصاني لتجاربنا الخاصة، كما أن الهلوسات والتوهمات لها المكانة نفسها للمدركات في العالم الحقيقي. يجعل هذا من المستحيل الإجابة عن السؤال المحوري: كيف تحدد الطبيعة التجريبية للمدركات ما نظن أننا ندركه، أي كيف تحدد الفينومينولوجيا المضمون الإدراكي. وحتى النظريات الفلسفية عن الإدراك، والتي لا ترتكب خطأ الحجة السيئة، لا يمكنها الإجابة عن هذا السؤال. يجادل المؤلف بأننا نستطيع تجاوز الأخطاء السابقة بتقبل فكرة "الواقعية المباشرة"، وهي وجهة النظر القائلة بأننا ندرك الموضوعات والظروف بصورة مباشرة.
يوضح التفسير النظري المحوري للكتاب كيف تحدد الفينومينولوجيا الخام للتجارب الإدراكية المضمون عن طريق دمج السببية القصدية مع الخصائص الإدراكية الأساسية للعالم، والتي تسبب التجربة. يفسر المؤلف أيضا كيف تؤدي بنية التجارب الإدراكية إلى مدركات رفيعة المستوى وشديدة التعقيد، والتي ترتكز على القدرات الإدراكية الأساسية المفروضة بيولوجيا.
من خلال المناقشات المستفيضة والأسلوب الواضح، يزودنا الكتاب بإطار لفهم المشكلة الفلسفية القديمة للإدراك، ويجعل كتابات فيلسوف بارز حول هذا الموضوع البالغ الأهمية مفهومة للقارئ العادي.
$1.00
ثلاث مدن مشرقية (الجزء الثاني)
العدد: 455
هذا الكتاب:
يشير المشرق إلى الأراضي الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وهي تحديدا الدول الحديثة: اليونان وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصر، التي كانت من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، جزءا من الإمبراطورية العثمانية.
في عصر الحروب الدينية، كان هذا المشرق، وتحديدا موانئه، بوتقة للتجاور بين مختلف الأديان والأقوام، وانتصبت فيه المساجد والكنائس والمعابد جنبا إلى جنب، وتجاورت فيه اللغات والثقافات والمواريث القومية. لكن هل كان هذا المشرق فعلا جنة للتعايش بين الأديان والأقوام، كما في المخيلة المعاصرة الميالة إلى الحنين إلى الماضي وتمجيده، ونسيان أهواله وصفحاته المظلمة، وكما تصور الروايات السكندرية المشرقية العربية الكثيرة؟ وعلى نحو أوسع من ذلك السؤال، هل كان من الممكن -في هذا الجو العالمي "الجهتدي" إسلاميا و"الصليبي" مسيحيا و"الاستعماري" و"المتعالي حضاريا" أوروبيا- أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوئام والتعارف والاحترام؟
ينتمي الكتاب الحالي إلى نوعية الكتابات التي تتباكى على المشرق الكوزموبوليتاني، ومع ذلك فإن الحقائق التاريخية التي يقدمها تنقض فكرة "جنة التعايش"، وتبرز الانفصال بين الجماعات المشرقية، وحالة الاستغلال المعمم من جانب الجاليات الأوروبية بحق الأهالي في مدن المشرق. وإن لم يكن المشرق "المتوسطي" جنة الحرية والتعايش، فإن فكرة المشرق الكوزموبوليتاني قد كسرت حدود الزمان والمكان، وشقت طريقها إلى مدن الغرب والشرق في صورة العولمة، وإن كانت المشارق الجديدة أكثر تعايشا وحرية ومساواة وعدالة، وأبعد عن الاستغلال والاحتقار الديني والقومي، على الأقل مقارنة بمشرقنا القديم.
$1.00
ثلاث مدن مشرقية (الجزء الأول)
العدد: 454
هذا الكتاب:
يشير المشرق إلى الأراضي الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وهي تحديدا الدول الحديثة: اليونان وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصر، التي كانت من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، جزءا من الإمبراطورية العثمانية.
في عصر الحروب الدينية، كان هذا المشرق، وتحديدا موانئه، بوتقة للتجاور بين مختلف الأديان والأقوام، وانتصبت فيه المساجد والكنائس والمعابد جنبا إلى جنب، وتجاورت فيه اللغات والثقافات والمواريث القومية. لكن هل كان هذا المشرق فعلا جنة للتعايش بين الأديان والأقوام، كما في المخيلة المعاصرة الميالة إلى الحنين إلى الماضي وتمجيده، ونسيان أهواله وصفحاته المظلمة، وكما تصور الروايات السكندرية المشرقية العربية الكثيرة؟ وعلى نحو أوسع من ذلك السؤال، هل كان من الممكن -في هذا الجو العالمي "الجهتدي" إسلاميا و"الصليبي" مسيحيا و"الاستعماري" و"المتعالي حضاريا" أوروبيا- أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوئام والتعارف والاحترام؟
ينتمي الكتاب الحالي إلى نوعية الكتابات التي تتباكى على المشرق الكوزموبوليتاني، ومع ذلك فإن الحقائق التاريخية التي يقدمها تنقض فكرة "جنة التعايش"، وتبرز الانفصال بين الجماعات المشرقية، وحالة الاستغلال المعمم من جانب الجاليات الأوروبية بحق الأهالي في مدن المشرق. وإن لم يكن المشرق "المتوسطي" جنة الحرية والتعايش، فإن فكرة المشرق الكوزموبوليتاني قد كسرت حدود الزمان والمكان، وشقت طريقها إلى مدن الغرب والشرق في صورة العولمة، وإن كانت المشارق الجديدة أكثر تعايشا وحرية ومساواة وعدالة، وأبعد عن الاستغلال والاحتقار الديني والقومي، على الأقل مقارنة بمشرقنا القديم.
$1.00
الخيال السياسي
العدد: 453
هذا الكتاب:
يطرح هذا الكتاب موضوعا نادر التناول في التحليل السياسي، ويتصدى له بطريقة مباشرة وشاملة. ويتناول الكتاب معنى الخيال السياسي، وكل ما شابهه أو التبس به، ثم يبين حاجة الحاكم والمحكوم إليه، ويشرح كيف يمكن للسياسة أن تكون مجالا للخيال في توزعها بين الإيهام والإبهام والإلهام، وكيف يمكن للخيال السياسي أن ينبع من استقراء التاريخ، والوعي بالمستقبل، وبصيرة القيادة، وروح الفريق، والتفكير الجانبي والتباعدي، ونظرية المباريات، والمحاكاة، وقرائح مبدعي الأدب، واستطلاعات آراء الناس، واستعراض التجارب الناجحة ودراستها.
ويعدد الكتاب سبل تنمية الخيال السياسي وشحذه، والمعوقات التي تحول دون ذلك مثل: الاستسلام للواقع، وبلادة صناع القرار، والتحكم البيروقراطي، ونقص المعلومات والاستهانة بها، والجهل بالتاريخ، وتقديس الموروث، والتفكير بالتمني، وسطوة الأيديولوجيا. ويطرح بعدها عدة مجالات لتوظيف الخيال السياسي مثل: عبور الأزمات، وبناء الخطط والاستراتيجيات، والحرب، ومكافحة الفساد، ومواجهة الإرهاب، وتعزيز الحس الأمني، وتقدير الموقف، وتفادي سلبيات الديموغرافيا السياسية، والبحث عن المثل العليا والفضائل الاجتماعية والسياسية، وتكوين الجماعات المتخيلة أو اختراع الهويات القومية، وتوظيف "الصناعات الإبداعية" في خلق التماسك الاجتماعي وصناعة الدور. وأخيرا، يعرض نماذج تطبيقية للتخيل السياسي قدمها أفراد ومؤسسات.
$1.00